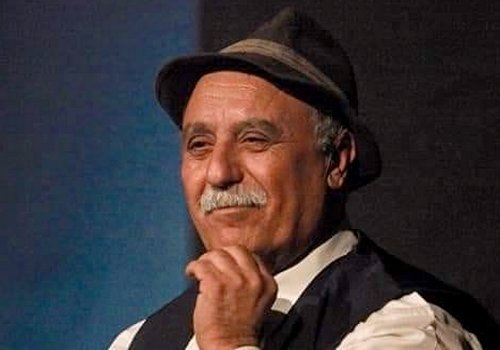الكاتب: محمد غزلي
خمس دقائق رفقة فتاة لا تخشى الغرق
(سلسلة نصيصات)
بفوطة بحر وقبعة شمسية وحقيبة ظهر فارغة سوى من ظرف بريدي كبير، قلت مع نفسي سأذهب لألقي التحية على بحر الوليدية وأخرج، أنفض أقدامي من الرمل أمام متاجر الكورنيش المتاخمة، ألتقط الصور، الصور المثيرة طبعا غير بعيد عن القوارب المقلوبة في الپلايا الأشبه بقوارب قراصنة القرن الإفريقي، أُلقي التحية بينما أنتظرت قدوم عديلي/صهري/نسيبي وزوجتي، مكثت جالسا قرابة نصف ساعة ما أتاح لي رؤية مقدار قوة تحملي فترة الانتظار تحت وهج الشمس، على مسافة مئتي متر من مرسى بحر الوليدية كفيلة بتلطيف الجو نسبيا، في يدي ظرف أصفر مغلق بلصاق غير معنون، اِكتفى المُرسل برقم هاتف طرفه الثاني.
أجلس تحت نخلة رصيف مقاهي الشاطئ مُسندا ظهري على الجذع المسنن للنخلة، يبدو أن فروع النخلة جُزَّت حديثا ولاتزال بقية سُعف مقطوعة متساقطة في دائرة الجذر تظلل التربة المسقية حديثا كذلك، الجذور المقطوعة كسكك المحاريث الخشبية.
كل شيء صامت. الذين يسرسرون مفاتيحهم في الهواء على جنبات الشوارع ينتظرون زبونا للكراء تركوا أماكنهم. وقراصنة صيد أراحوا قواربهم ودخلوا المقهى قبل الماتش، لا أعرف من سيلعب. كنت أفكر في شيء من الفراغ فحسب بعيدا عن البيت، تمنيت لو أنني بلا زوجة، أو أن أكون مثل عجوز هيمنغواي معتقلا في البحر معزولا بلا خطيئة. أخطف السمك ببندقية الصيد وأخمن أن البندقية التي فجر بها هيمنغواي رأسه لم تكن للصيد. كانت خاصة بالانتحار.
مثل سحر التخييل لم أعرف كيف اقترب شاب يرتدي قرطا. في عنقه سلسة ازرار بلاستيكية سوداء ينظر إلى الأماكن بازدراء كما يفعل الاوغاد الباحثون عن الصيد. صوت الموسيقى آت بطريقة لولبية من متجر المثلجات والمأكولات المُعَلبة يرفع الى النهاية وينقص تدريجيا تبعا لتيارات الهواء البحري كما لو كانت جوقة الموسيقى في طور الانتهاء من إيقاع المقطوعة.
بدا لي أن رجل المفاتيح مبتدئ في المهنة، أو أن سيرته المهنية في طور البداية، وأن خدماته تحتاج إلى المزيد من التكوين، بادرته:
«لماذا لا تضع إعلانات على وسائل التواصل الاجتماعي، هل يحتاج الأمر إلى دورة تكونية في كيفية تسويق الشقق الفارغة».
لم يعتقد أنني أتحدث إليه. فتح شفتاه المكرمشتان الملتصقتان:
«لا شيء، إنهم يخرجون من الماء يركبون سياراتهم ويذهبون. لم تعد لهم رغبة في استئجار الشقق ليلة أو ليلتين».
«هذا ما تفعله شبكة الطرق السيارة، الكراء بسعر مرتفع يدعو السياح الى قضاء يوم والعودة، يفضل العودة على المبيت..».
يرمق سيارة شباب رياضية، يحرك حامل المفاتيح بحركة هوائية تغري بأن ثمة غرف شاغرة وبأثمنة تفضيلية، شباب السيارة يفتحون زجاجات السيارة الأربع بناظارات شمسية وأقمصة عارية الأذرع والصدر وشورطات قصيرة لا يعبأوون بإغراءات رجل المفاتيح. السائق يخرج يده ممددة الأصابع من نافذة السيارة كما لو كان يريد القبض على كتل الهواء الباردة، يمطط أصابعه للحصول على أكبر كمية من الهواء، يشعر بدغدة الهواء المجلوب بسرعة التمانين كيلومتر بالساعة، نسيم كفيل بتحويل قِوايَ الدفينة الى مثاليات الحُلم والرغبة بالقوة والفعل، ألتقط الفتنة وأضع يدي على صدري أمسد حبال العنق وحبات العرق، ينظر السائق إلى رجل المفاتيح نظرة تجاهل، تبتعد السيارة، نتتبع مؤخرتها، نتهجى أرقام لوحتها الأجنبية والموسيقى الصاخبة التي سرعان ما اندمجت بصدى البحر الآتي من ارتطام الموج بالمرتفع الصخري، نقبض على الحروف الأولى للوحة LP طاليان، يدير رجل المفاتيح ظهره ويلعن بنبرة مكتومة:
«أراهن أنهم سيعومون وسيغادرون، لا حاجة لهم بغرف، أعرف، لقد اكتفوا بسيارات غرف استمتاع متنقلة» يتأوه.
سألته متفحصا الطريق الممتلئة بالسيارة المتوقفة تنتظر حركة الزحام:
«يُفترض أن تجلس قليلا، الوقوف طول النهار أمر مُتعب».
يدس يده في الجيب الخلفي لسروال الجينز الباهت:
«إذا أردت أن تجلس اِبحث عن وظيفة أخرى، عن عمل مكتبي».
يعود لتحريك حاملة المفاتيح المتختمة بإصبع السبابة، لا أعرف لم بدت لي أشبه بسُبحة إلكطرونية لعد التسبيح.
يسأل:
«هل أنت من هنا، لا تبدو غريبا عن الوليدية، من سُمرة جلدك البني تؤشر على أنك من مُرتادي الشاطئ».
«جئتُ إلى هنا من أجل الشاطئ، أسكن مؤقتا عند أصهاري، يربطني بمرساة الوليدية عومة بداية الصيف وحرارة سيبتمبر القادم، أتسكع، وربما أربط علاقات مؤقتة».
تلقيتُ مكالمة العائلة بأنهم لن يأتوا، الآن سأرسل مقود السيارة وأدعها تبحر كما تشتهي متحررا من تبعات إظهار جسدي للعائلة، أحسستُ برغبة في دفن الجسد بعمق المحيط، وبسبب ميولاتي في أخذ مسافة عن مظلات العوائل، اخترتُ موقعا فوق مرتفع رملي خال. نزعت ملابسي وغطست بعيدا واثقا من إمكانياتي في القفز ، أنام على ظهري فوق الماء الراكد وأنقلب شقلبة الدلفين فور تصخم الموج ثم أمد الأذرع كأجنة الفراشة بما يعطي الانطباع بأنني في غنى عن أي سباح منقذ، وسرعان ما التحق بالمكان أمرأة وفتاتان، خمنتُ أنهما أختان، بقصات شعر تحت العنق بقليل وبملابس سباحة متحررة جدا ورقيقة من قطعتين؛ حمالات صدر خفيف وپيكيني يبدي الأطراف الشهيرة لفتيات البرازيل. دخلت إحداهن الماء ببطء كما لو كانت تخشى برودة الغطسة الأولى أو لسعة الغطس في حوض الماء المثلَّج، وشيئا فشيئا لَجَّجت قليلا ثم ارتمت شابكة يديها في الرمل وشرعت تعوم عومة السيقان المكسورة، كنا الوحيدين، أدركتُ أنها في وضعية الجسد الخائف من الغرق، ابتعدتُ عنها بأمتار وأبحرتُ حيث أمكنني تلقي صفعات المياه المتحولة من الأخضر إلى الأزرق، هي الأخرى شعرت بملل المياه الضحلة، تجرأت متعلقة باستئناس الرجل الفراشة، لم يعد بوسعي تجاهل خطر رغبة الأنثى بلوغ المياه الصافية، اِستدرت عائدا، اقتربتُ منها في محاولة للتحدث بداعي الخوف عليها من اللعب الجريء مع البحر:
«مرحبا بوگوصة، بصحتك، استمتعي».
ترد بابتسامة مهذبة:
«مرحبا، الله يعطيك الصحة».
«ماذا عن عائلتك، ألا يرغبون في العوم؟».
التفتت ناحيتهم وهزت كتفيها:
«لا يهم، تعودتُ على النفاذ إلى البحر أولا».
حثوت حفنة ماء أمسد بها شعر رأسي معيدا له تثبيت تسريحات ممثلي أفلام مارتن سكورسيزي:
«تبعتيني للعمق!! واش باغا تغرفي؟ ما خايفاش على راسك؟ ربما استهوتكِ مرونة الموجة الثالثة، يجب أن تحذري تقلبات الموجة الرابعة فما فوق».
«ميغسي خويا، معنديش تجربة، ماشي بحالك، كتبان محترف، لا أعرف، حسنا، سأكتفي بالمياه الضحلة».
ولإشعارها بدفء النجاة شريطة البقاء بالقُرب، قلت:
«معليش معليش، هيا، اتبعيني، عومي حدايا، ماحدي أنا معاك، ماتخافيش، عومي على راحتك، سأكون ملاكك المنقذ».
.......